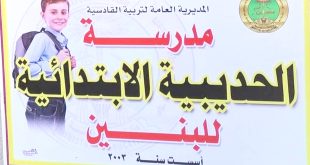كتب: امجد حميد – العراق
 تولد الأُمم وهي تعيش كل يوم من ايامها خطر الفناء, حتى اذا توهمت خلودها ابيدت, بطريقة او باخرى, واصبحت جزءاً من التاريخ لا اكثر. ولان هذا الخطر يلازمها كما يلازم الطفل الرضيع امه, تصبح كل امة اما متصدية للمعتدين او امة تعتدي على الاضعف منها لنفس السبب.
تولد الأُمم وهي تعيش كل يوم من ايامها خطر الفناء, حتى اذا توهمت خلودها ابيدت, بطريقة او باخرى, واصبحت جزءاً من التاريخ لا اكثر. ولان هذا الخطر يلازمها كما يلازم الطفل الرضيع امه, تصبح كل امة اما متصدية للمعتدين او امة تعتدي على الاضعف منها لنفس السبب.
ولان الملوك والحكام لا يولدوا طيبين بالفطرة, بل تجاراً لمخاوف شعبهم, يكون الخوف من الفناء هو اعظم اسطورة يحملها الحاكم لشعبه. فاما تكون لبقاء سلطانه لنبذ العدى, او لتحقيق مساعيه في التوسع وابعاد الخوف منهم. هذه هي احدث صورة نستطيع ادراكها واختزالها عن الاستعمار. انها صورة ادبية رومانسية عن صراع فكرة السلم والحرب بين الشعوب والحضارات.
وطبع الانسان شعوره بالملل من تكرار اي شيء, حتى اخطاءه, فيضطر لاعادة صياغة كل شيء بما يتناسب وطبيعة تصوراته وارائه وافكاره وحياته المستحدثة. لذا رأينا استعماراً قديماً وحديثاً ومعاصراً بشتى اشكاله الحالية. لكن ما غاب عن الجميع, حتى كتّابنا وفلاسفتنا وأدبائنا, هو ان كل اعتداء مجتمعي حضاري من قوم او دولة او حضارة على اخرى سيصاحبه رد عكسي بالغالب, بعد ايمان المعتَدي القضاء على المعتدى عليه, لا تسلب الاول سلطانه على الاخير فقط, بل تتعدى ذلك لتصل حدود التوغل في احشاء مجتمعه وحضارته وامته, حتى يفقد المعتدي هويته وتتحول الى هوية المعتدى عليه كضريبة لكل ما حدث. هذا ما يجب ان يسأل الجيل الحالي نفسه به وهو ما سنشرحه ونفهمه. ولا يحدث ذلك الا بعد ان نسمي هذا الحدث الافتراضي الذي ندّعيه, والذي نطمح ان يكون يوماً جزءً من دراسة فكرة صراع الانسان مع اخيه تحت اسم الاستعمار. والتسمية التي اطلقناها على ردة الفعل هذه التي ستشغل بحثنا المبسط, نسبياً, عن هذا المفهوم هي “الاستعمار المعاكس” او (Adverse-Colonialism).
ويبدو الحديث بعيداً ومبهماً لهذا المفهوم الجديد, وهو في نعومة اظفاره, مالم نعطي صورة مبسطة للاستعمار من الاساس او كيف نراه نحن ابناء الالفية الثالثة. وما نقصده بطريقة رؤيتنا له هو الخروج عن الطريقة التقليدية في رؤية الاستعمار وتصوراتنا له بما يتناسب وطبيعة جيلنا الجديد. فهل مفهوم الاستعمار هو احتلال شعب او امة او حضارة ما لاخرى فقط ام ان الامر اكبر من هذا التصور؟ وهل الشكل الاستعماري الكلاسيكي هو ذاته الذي نعيشه اليوم ام ان هناك استعماراً شمولياُ يحكمنا اليوم بطريقة مختلفة؟
ان السردية التقليدية المطروحة لمفهوم الاستعمار مرفوضة جزئياً كونها لا تلبي احتياجات وطرق تفكير جيلنا الحالي بعد كل النتاجات المجتمعية التي نراها في العالم الحديث. هذا الجيل الذي قرأ روبنسون كروزو لدانيل ديفو, رحلات جوليفر لجوناثان سويفت, مسرحية العاصفة لشكسبير, قلب الظلام لكونراد, او حتى الشوك والقرنفل للسنوار وعائد الى حيفا لكنفاني في هذه الفترة التي تمر بها فلسطين بحرب مع اسرائيل. هذا الجيل الذي يعرف ادوارد سعيد وكتابه الاستشراق, فرانس فانون وكتابه معذبو الارض, وليدنا ت. سميث وكتابها مناهضة الاستعمار, وغيرهم قد سئموا من تكرار طريقة تفسير الاستعمارية وكيفية تعاملها بنفس الطريقة. ومع ذلك يجب علينا ان نطرح الطريقة السردية الكلاسيكية بصورة مختزلة قدر المستطاع ونضيف عليها لاحقاً رؤيتنا الجديدة في هذه السياقات.
تطرح الرؤية التقليدية الاسس الاستعمارية وفق كثير من الشروط والعوامل, لكن الاعمدة الجوهرية التي لا يستقيم بدونها اي استعمار, قديماً كان او حديثاً, هي ثلاث: اللغة, التفوق, والاختلاف. وكون بحثنا لا يخص الاستعمار بشكل اساسي بل نهايته, فلن نسبر غوره كثيراً. بل سنعطي اهم الجوانب التي تخص هذه الاعمدة وسنستخدمها لاثبات رؤيتنا فيها.
فاللغة هي كل جانب لفظي او سمعي او مقروء او مكتوب يقدمه المستعمِر للمستعمَر. فنحن نعرف ان كروزو قد قدم اسم فرايداي “Friday” لوحشه المستأنس فامتلكه. ونرى فاكهة برقوق فكتوريا في ايرلندا دلالة واضحة على اللمسة التي حافظ عليها الاستعمار البريطاني على تلك الارض. وهذا لا يشمل الشكل الغربي فقط في استخدام اللغة, بل ان الامبراطوريات العربية المتعاقبة قد ساهمت في استخدام اللغة كسلاح استعماري يفرض نفسه على اوروبا في العصور الوسطى. حتى وصلنا اليوم لما يقارب 900 كلمة عربية في قاموس اكسفورد الانكليزي.
وقد لا تنجح استراتيجية اللغة دوماً بطريقتها التقليدية, فقد تنشأ دولة لا تحمل أرثاً لغوياً كافياً ليمدها بامتدادها, كالمغول والاتراك على سبيل المثال. فاما المغول فاستبدلوا فرض السيادة اللغوية على هدمها, فحرقوا واتلفوا كل الاثار الفكرية والعلمية في كل البلاد التي احتلوها. واما الاتراك فحاولوا في ايامهم الاخيرة فرض سياسة التتريك على البلدان التي يسيطرون عليها الا انها لم تتعدى حدود الموصل. هكذا يتبين ان اللغة هي اداة استعمارية فتاكة وعملية وتديم السيطرة حتى بعد انتهاء الاستعمار على ارض ما. ويكفينا دليلاً على محورية اللغة كتاب “ازالة الاستعمار” “Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples” الذي شرحت فيه الكاتبة ليدنا ت. سميث بالتفصيل كيف يستخدم الاستعمار مفهوم اللغة لتثبيت وادامة استعماره:
“تعد اللغة والاستشهاد بالنصوص غالباً من اكثر العلامات الواضحة على التقاليد النظرية المتبعة للكاتب. وقد استندنا في هذا الكتاب الى افكار مختارة ودراسات اكاديمية وادبية لنبين بان قد تنسب هذه الافكار للتقاليد الغربية او السكان الاصليين. وقد لا تنسب لاي منهما. نقول ذلك لأنـنا، مثل الكثيـر من الكتّاب الآخـرين، نزعـم أن “نحن”, الشـعوب الأصليـة، الشعوب الملونة، شعوب (الآخـر)، بأي اسـمٍ كان, لنا حضورنا في الخيال الغربي, في تركيبته ونسيجه, في احساسه الداخلي ولغته, في صمته وظلاله, وفي تهميشه وتقاطعاته.” (ازالة الاستعمار, ص 14, دار Zed Books, ترجمتي )
وهذا ما سيستدرجنا لسؤال لاحقاً في الاستعمار المعاكس, وهو: “هل لغة المستعمِر لن تواجه رداً مقابلاً او استعماراً معاكساً من قبل المستعمَر؟”
يمارس المستعمِر اساليب حكمه وسيطرته على المستعمَر من خلال اثبات تفوقه عليه وليس فقط باحكام قبضته عليه, والا سيثور بوجهه يوماً. وتتعدد اساليب اثبات التفوقية التي يتبعها اي مستعمِر على مستعمَر, فقد تكون تفوقية عسكرية او فكرية او عرقية او دينية وغيرها. ان التفوقية التي يطرحها المستعمِر هي المحرك والدافع الاساسي لكل استعمار وهو الذي يضفي شرعيته الوهمية, اذ بامكانها ان تطبق على اي مجموعة مستعمَره رضيت بطول بقاء الاستعمار وحمل سرديته. وكان نصيب كتاب “الاستشراق” كبيراً في شرح وتوضيح هذا المحور في فكرة الاستعمار اذ يقول ادوار سعيد بهذا الصدد:
“ولقد كانت الهيمنة، أو قُل النتيجة العملية المترتبة على الهيمنة الثقافية، هي التي كتبت للاستشراق استمراره مما يسميه (دنيس هاي) (فكرة اوروبا) ويعني بها الفكرة الجماعية التي تُحدد هويتنا ( نحن) الأوروبيِّين وتفرق بينها وبين جميع (الاخرين) غير الأوروبيِّين، بل إننا نستطيع أن نقول إن العنصر الرئيسي في الثقافة الأوروبية هو على وجه الدقة الذي جعل تلك الثقافة مهيمنة داخل أوروبا وخارجها، أي فكرة الهوية الأوروبية باعتبارها هوية تتفوق على جميع الشعوب والثقافات غير الأوروبية. هذا إلى جانب هيمنة الأفكار الأوروبية عن الشرق، وهي التي تُكرر القول بالتفوق الأوروبي على التخلف الشرقي، وهو القول الذي عادةً ما يتجاهل إمكان وجود مفكر يتمتع بدرجة أكبر من الاستقلال أو التشكك وقد تكون له آراؤه المختلفة في هذا الأمر.” (الاستشراق, ص39-40, ترجمة محمد عناني, مؤسسة هنداوي)
لكن المثير للعجب وما علينا ان نسأل عنه هو: هل تسقط فكرة التفوقية بمجرد بدء مقاومة الاستعمار ومواجهته وتنتهي بانتهاء الاحتلال؟ ام ان هناك بعداً ستضيفه على المتحرر والمعتدي, المستعمِر والمستعمَر, سيدوم اثره الى ما بعد انتهاء الاستعمار بكثير؟
تمثل سياسة الاختلاف, او انا/الاخر, اخر عمود مركزي لكل استعمار في تاريخ البشرية. فلا يستقيم استعمار بفرض لغة المستعمِر او تهميشه للغة المستعمَر فقط, ولن يكفي تصدير وتوغل واستغلال سردية تفوق المستعمِر على المستعمَر, فاللغة قد تسترد بعد تهميشها وقد يدافع عنها, وتسقط فكر التفوق حين يقرر المستعمَر الانتفاض فقط على المستعمِر. فوظيفة تثبيت الاختلاف هو ادامة, وتأبيد ان امكن ذلك, حكم المستعمِر على المستعمَر, حين يؤمن الاول انه في علاقة عضوية وحقيقية مع الاخير لانه مختلف عنه. وتصدير هذا الاختلاف يختلف في مقاييسه المتطرفة, حتى وصل الى تجريد المستعمَر من انسانيته او اعتباره كائناًً غير مكتمل. وقد نجح فرانس فانون في كتابه “معذبو الارض” في تسليط الضوء على هذا الجانب ونقده بصورة عظيمة, خصوصاً وان الموضوع وصل الى استخدام الطب كوسيلة لتبرير الاستعمار:
“إن البروفسور بورو يرى أن حياة السكان الأصليين بشمالي أفريقيا إنما تسيطر عليها المطالب المتصلة بالدماغ المتوسط . فكأنه يقول إن السكان الأصليين بشمالي أفريقيا محرومون من اللحاء الصاعدي. والبروفسور بورو لا يتحاشى هذا التناقض، وها هو ذا في عام 1939 يوضح اراءه، بالتعاون مع تلميذه سوتر الذي أصبح الآن أستاذ الطب العقلي بمدينة الجزائر، قائلًا في مجلة (الجنوب الطبي الجراحي): ليست البدائية نقصًا في النضج، لیست توقفاً ملحوظاً في نمو الحياة النفسية العقلية، إنها حالة اجتماعية بلغت آخر مراحل تطورها، حالة متلائمة تلاؤماً منطقياً مع حياة مختلفة عن حياتنا.” (معذبو الارض, ص 242)
رغم هذا التطرف الاستعماري لترسيخ الاختلاف وخلق تفاوتات خلقية وبيولوجية بين المستعمِر والمستعمَر, نرى الغرب المتطور يحمل اليوم في اشد قطاعاته حساسية اكبر نسبة من الشرقيين, وهو القطاع الطبي الذي شكل تحرير سوريا في بداية هذا العام تخوفاً حقيقياً من خسارة كوادرها الطبية التي يشكل فيها السوريين اكبر عدد من موظفيها. هذا في الواقع لا يدفعنا الى محاولة فهم طبيعة تحقيق ذلك مع المستعمَر بل كيف نفذ بطلان تلك النظريات الى كيان المستعمِر, كيف اصبح الطب الذي دعم هذه النظرة يحتوي على نسبة كبيرة من الشرقيين والافارقة؟ وكيف اصبح احد الشعوب المنادية بالبشرة البيضاء, كفرنسا, تمتلك منتخباً كاملاً من الافريقيي الاصل؟ وكيف اصبحت سلسلة رؤساء المملكة البريطانية تحتوي على شخص ذا اصل هندي, ريشي سوناك, بعد ان كافحت لتبين ان احتلال بريطانيا حق طبيعي والهي لهم؟ هنا تبرز مهمتنا الاساسية لاحياء هذا المفهوم الجديد ليوضح كل هذه الزوايا المعتمة طيلة هذا التاريخ لينورها جيلنا بفهمه ووعيه بها.
ان الاعمدة الجوهرية لكل استعمار قد بينت لنا ان كل انواع الاستعمار, قديمها وحديثها, خاضعة لهذه التركيبة المعقدة. وان الاختلاف الواسع بين الشكل الاستعماري الكلاسيكي وما نراه اليوم يمثل التبرير المنطقي لعدم ملاحظة الاسبقين, حتى العلماء والادباء, للرد الفعلي الطبيعي المعاكس للاستعمار. هذا الاختلاف سببه طرق الاستعمار وتحديثها اولاً وطول الاستعمار وامتداده ثانياُ.
فاما الطرق الاستعمارية, فالاستعمار القديم لم يكن الا عسكرياً يلحقه بعدها باقي القطاعات كالاقتصاد والحكم والمجتمع وغيرها, اما في القرنين الاخيرين فتحول الاستعمار الى اقتصادي بالمعنى المطلق, اي اصبح الدافع الاقتصادي غاية لا وسيلة بعد ان كان العكس قديماً, فتتوج الاستعمار البريطاني بشركة الهند الشرقية كي تضفي شرعية لاستعمارها. واما طول الاستعمار وامتداده فنلحظه في مفهوم الدولة القطرية (Nation State) الذي مثل قفزة استعمارية نوعية بعد ان كان حكم الامبراطوريات والحضارات الاممية هما الشكل السائد للعالم, اذ نرى اليوم ان الحروب القائمة يتم رفضها على اساس حدود وهمية مرسومة ومبررة غربياً لا من اصحابها. وهو ما سنستفيض به قليلاً لاحقاً لتبيان محوريته في الاستعمار المعاكس.
يتضح الان صعوبة تقفي اثر الاستعمار المعاكس, كمفهوم لا يستقيم تعريف له دون معرفة اثره, بعد ان علمنا ووضح لنا ان لا احد اشار له من الاسبقين من قريب او بعيد ولا من ادباء ولا علماء. لكن ذلك لا يعني ان العصر الحديث لم تظهر في طياته اثار ذلك سواء في اعمال الكتّاب او حياتهم بذاتها. وان ابرز عمل تتضح فيه معالم الاستعمار المعاكس هو كتاب “صدام الحضارات” للكاتب الامريكي صمويل هنتنجتون. اذ يمثل الكاتب وكتابه احد العلامات الاساسية والبوصلة المركزية التي سنتبعها لفهم الاستعمار المعاكس بشكل بسيط في هذا البحث:
“مرت العلاقات بين الحضارات عبر مرحلتَين وهي الآن في الثالثة، ولمدة تزيد على ثلاثة آلاف عام بعد ظهور الحضارات كانت الاحتكاكات بينها إما غير موجودة أو محدودة أو متقطِّعة أو متوترة، مع بعض الاستثناءات. وطبيعة هذه العلاقات تُعبر عنها جيدًا العبارة التي يستخدمها المؤرخون عادة بوصفها على أنها (مواجهات).” (صدام الحضارات, ص 65, ترجمة طلعت الشايب, مؤسسة هنداوي)
هنا امكننا ان نفهم وبصورة مختصرة اننا نتعامل مع حقبة زمنية مختلفة تماماً عن الحقب السابقة, وهو ما يجعلنا نتقبل عدم ملاحظة الاسبقين لاحتمالية وقوع هذا الحادث وهذا المفهوم الذي نريد تصديره. ببساطة, حتى نفهم الاستعمار الحديث والاستعمار المعاكس فعلينا ان نراه بعيون هنتنجتون وببوصلته لنتمكن من ايجاد اثاره التي انبنت على تغير الشكل الاستعماري في العصر الحديث.
من الضروري ان ندرك ما يعنيه هنتنجتون بمصطلح (صدام الحضارات) كي نعرف ما هو شكل الاستعمار الحديث وكيف تباينت فيه ماهية الاستعمار المعاكس اكثر من ذي قبل. وتعريف هنتنجتون لهذا المفهوم يوضح لنا الهوة الزمنية التي فصلت العالم القديم عن الحديث اليوم:
“الحضارات هي القبائل الإنسانية النهائية، وصدام الحضارات هو صراع قبلي على نطاق كوني. في العالم الناشئ، قد تقيم الدول والجماعات التي تنتمي إلى حضارتين مختلفتين علاقات وتحالفات تكتيكية محدودة وخاصة بغرض تنمية مصالحها ضد كيانات تنتمي إلى حضارة ثالثة أو من أجل أهداف مشتركة. على أن العلاقات بين الجماعات التي تنتمي إلى حضارات مختلفة غالبًا لن تكون وثيقة، بل عادة ما تكون باردة وعدائية في معظم الأحوال. العلاقات بين الدول التي تنتمي إلى حضارات مختلفة والموروثة عن الماضي مثل تحالفات الحرب الباردة العسكرية من المرجح أن تضعف أو تتبخر.” (نفس المصدر, ص271)
نفهم الان النقطة الفاصلة بين الشكل الاستعماري القديم والحديث. ان مفهوم الدولة القطرية Nation State هو البديل الاستعماري الامثل الذي رأى الغرب فيه مستقبل ثبات وامتداد استعمارهم على الشرق, ما يعني الغاء فكرة الحضارات الممتدة الاطراف والواسعة ديموغرافياًً وتفتيتها لتسهل حكمها واستغلالها اقتصادياً:
“بشكل عام، وكما يوضح كثيرون: الصرب والكروات والمسلمون عاشوا معًا في يوغوسلافيا في سلام لعدة عقود. المسلمون والهندوس في الهند كذلك. الجماعات الإثنية والدينية المتعددة في الاتحاد السوفيتي تعايشت باستثناء حالات قليلة كان سببها الحكومة السوفيتية. التاميل والسنهاليون أيضًا عاشوا في هدوء على جزيرة كانت توصَف دائمًا بالجنة الاستوائية. التاريخ لم يمنع أن تسود تلك العلاقات المسالمة نسبيٍّا لفتراتٍ طويلة من الزمن، ومن هنا فإن التاريخ بمفرده لا يمكن أن يفسر انهيار السلام، ولا بدَّ أن هناك عوامل أخرى تدخلت في العقود الأخيرة من القرن العشرين. أحد هذه العوامل: التغيرات التي حدثت في التوازن الديموغرافي. ” (نفس المصدر, ص337)
هذا هو صلب المشروع الاستعماري الغربي الجديد المتمثل بالدولة القطرية Nation State والذي قسم العالم من وجهة نظر اوروبا المسيحية. بل ان بامكاننا ان نرتجل ونقول ان هذا المفهوم ليس نابعاً من مشروع غربي مسيحي الغطاء ,ان صح التعبير, فقط, بل انه نابع من الطبيعة الديموغرافية والتاريخية لاوروبا بذاتها. فليس صدفة ان نرى التحالف الانجح والوحيد في عالمنا اليوم هو الاتحاد الاوروبي, والذي يجمع بلداناً صغيرة نسبياً ولا تجمعها لا لغة ولا ثقافة ولا دين, بينما نرى مسعاها لتفكيك باقي الانظمة الحضارية والاجتماعية التي تمتلك مساحات جغرافية اوسع بكثير من البلدان الاوروبية.
هذا القدر المختصر يكفينا لنفهم اننا نتعامل مع شكل استعماري فريد, يتعامل مع الثالوث الذي وضعناه, ويكرس الاقتصاد كغاية لا وسيلة, ويخالف الفطرة التاريخية التي اعتادت الشعوب عليها لحفظ اممها المعبئة بكل رموز ثقافتها.
لننشأ فرضيتنا الان ونفترض ان هناك دولة, حضارة, او امة ما, نصطلح عليها اختصاراً بـ((كيان مجتمعي)), قررت ان تستعمر كياناً مجتمعياً اخر. من البديهي الاعتقاد ان يتجه الكيان المستعمِر لاستثمار واستغلال الثالوث الجوهري (اللغة, التفوق, الاختلاف) في اول لحظة من الاستعمار. الا ان هناك خطوة محورية تسبقه وتمثل اهمية كبيرة في الاستعمار وهي (السردية الاستعمارية).
ان الكيان المستعمِر هو الفئة المستهدفة الاولى للسردية الاستعمارية. فالسردية الاستعمارية هي ما تشرعن وتبرر وتقونن كل الممارسات التي يتخذها وسيتخذها الكيان المجتمعي المستعمِر على المستعمَر من جهة, وهي ما ستقوض وتجهض وتستبعد كل الفرص والجهود التي قد يبذلها الكيان المجتمعي المستعمَر ضد المستعمِر من جهة اخرى. باختصار, ان ما يسبق قناعة وبطش المجتمعات المستعمَره هو سردية وتلقين الشعوب المستعمِره. فلن تستطيع ان تاتي بجيش يفيك بالغرض دون شعبك, ولن يخرج شعبك ان لم يؤمن بسردية حقيقية تبرر له كل افعاله وتوضح له ما سيكسب من كل ما سيخسره من دماء كيانه المجتمعي.
جَهِزَ الكيان المستعمِر واستوعب سرديته الملقنة من حكامه, سواء كانت سردية دينية او ثقافية او حضارية او فكرية, واعد نفسه للانطلاق نحو الكيان المجتمعي الاخر ليستعمره. اي انه قد حَمِلَ الثالوث الاستعماري وهو في طريقه ليفرضه على الكيان المجتمعي المستعمَر. ففرضه ونجح في ذلك واستعمره.
وكما غفل السابقون خطوة استعمار الحكام لشعوبهم قبل الشعوب الاخرى, اي الاستعمار الداخلي بفرض سردية على الشعب قبل الاستعمار الخارجي, فقد غفلوا ايضاً التشكيل الفكري الذي يسبق مناهضة الاستعمار بل ويتبعه ايضاً موازياً مرحلة ما بعد الاستعمار (Post-Colonialism) داخل كيان المستعمِر والمستعمَر. هذا الاغفال يرتقي لمرحلة التهميش الكامل في الادب والنقد السياسي والتاريخي. وخير شاهد على ذلك مسرحية “العاصفة” “The Tempest” لشكسبير, اذ رأينا اريل, المساند لبروسبيرو, وكاليبان المناهض له من عيون بروسبيرو نفسه, بل ان خروجه من الجزيرة لم يفقده شيئاً ولم يكسبه في الوقت ذاته. على عكس اهل الجزيرة التي ابقت المساند والمناهض يستمرون في قتال بعضهم البعض. فحتى لو نسب الفضل لشكسبير في اعطاء الصورة النمطية للكيان ما بعد الاستعمار, فهو قد فشل في معاينة اثار الكيان المستعمَر على المستعمِر, بل وحتى عدم الاشارة الى احتمالية وجود اثار سيحملها المستعمِر من المستعمَر. اي من عيون سرديته.
ولكن ما هو الشكل الفكري الذي نعنيه؟ انه ببساطة الاستعمار المعاكس (Adverse-Colonialism). ولا نقصد به محاربة الاستعمار والتحرر منه بل مجابهة السردية المفروضة من قبل الكيان المجتمعي المستعمِر على المستعمَر واسقاطها. ومحاربة هذه السردية لا يأتي فقط من داخل الكيان المجتمعي المستعمَر فقط بل حتى من المستعمِر, ليس من افراد المستعمَر فقط بل حتى من المستعمِر, وليس فقط اثناء فترة الاستعمار وينتهي عند انتهاءه, كما هي فكرة مناهضة الاستعمار وما بعده, بل تمتد حتى تهمش السردية القديمة لدى المستعمِر وتستبدلها بسرديتها او على الاقل تجعلها شكليةً لا فائدة منها. نعم, ان الاستعمار المعاكس يبدأ من اول لحظة من الاستعمار ولا ينتهي ابداً, انه ثأر الكيان المجتمعي المستعمَر من المستعمِر الذي سياخذه كضريبة على كل شيء سلبه من الاول.
نستكمل الان فرضيتنا ونعتبر ان المستعمِر قد حقق العمود الجوهري الاول من الاستعمار وهو اللغة. وسواء حققه بتثبيت ونشر لغته او بتهميش لغة المستعمَر فهو سيعتبر ذلك, سواء من منظور شخصي او ادبي او سياسي كلاسيكي, نجاحاً استعمارياً مثمراً. لكن هل نحن نرى اللوحة بكامل اركانها وزواياها ام ان هناك عتمةَ نجهلها ونغشاها؟ سنعطي احتمالاً ان هناك صورة مكتملة من هذا النجاح وهو دولة ايرلندا. فرغم طول المعارك في تاريخها مع بريطانيا, تتبنى ايرلندا اليوم اللغة الانكليزية الخاصة بها. لكن الغريب في الامر ان هذا النجاح قد حول الطاقات والنجاحات اللغوية الى غير اهله بصورة متناقضة! اذ ان اكثر الاعمال الادبية التي تمثل اللغة الانكليزية هي ليست انكليزية , جغرافياً, بل ايرلندية, وطلاب كلية الاداب, قسم اللغة الانكليزي, في العالم يشهدون بذلك حين يرون جُل من تناولوا اعمالهم الادبية كانوا ليسوا من الاراضي الانكليزية ابداً.
لا يستقيم احتمال النجاح في هذا الحد, اذ بامكان المعترض على فكرتنا القول بان ذلك هو نجاح بذاته اذ اصبحت الارض وشعبها المستعمَر جزء لا يتجزأ من الكيان المستعمِر حتى وان قررت يوماً ان تستقل. ومن الطريف ان نرى الرد على هذا التعليق اتي من ايرلندي رافض لتلك الفكرة واللغة وينتقدها من خلال اللغة نفسها كرؤية سريالية قل نظيرها. انه الكاتب الايرلندي جيمس جويس وروايته المميزة “صورة الفنان في شبابه” “A Portrait Of The Artist As A Young Man” التي جعلها مثالاً للفكرة الثورية الايرلندية من تمثال دانيال اوكونيل الى سخريته من اللغة التي يتكلمونها:
“ان اللغة التي نتحدث بها هي ملك هذا الكاهن قبل ان تكون ملكي. اليس هنالك فرق في نطق كلماتِ مثل (الوطن), (المسيح), (الجعة), (السيد), حين تخرج من شفتيه ومن شفاهي! بالكاد الفظ او اكتب حرفاً من هذه الكلمات ولا تعتصر روحي قلقاً وريبة. لغته المألوفة والاجنبية تماماً عن كينونتي, ستكون دوماً لغة مكتسبةً لم اخلقها او اقبل كلماتها, فدام صوتي يصدها عني, ستشمئز روحي في ظلال لغة هذا الكاهن الى الابد.” (صورة الفنان في شبابه, ص 234, دار بلانيت ايبووك, ترجمتي)
هذا هو نواة مفهوم الاستعمار المعاكس وماهيته. ان الكيان المجتمعي المستعمَر حتى وان فشل في حفاظه على نسيجه اللغوي, لأي سبب كان, فهو اما سيستخدم نفس لغة المستعمِر لانتقاده ومحاربته, او ان يستخدم الكاتب شخصيته كردة فعل على الاستعمار ويعكسها في كتابته, او حتى يدافع عن لغته بتهميش لغة المستعمِر من خلال لغة المستعمِر بذاتها.
وكان نصيب جيمس جويس كافياً للحالة الاولى. اما الحالة الثانية فنراها في شخص جوزيف كونراد وروايته “قلب الظلام” وليس في لغته او روايته. نعم, ان الاستعمار المعاكس قد اوجد نفسه في شخص كونراد وكتاباته من خلال المشاهد الاستبدادية التي شاهدها كونراد بنفسه ولم يساهم الشعب المستعمَر باي شيء سوى باستمرار اسلوبه الاستعماري امامه لا غير.
واما الحالة الاخيرة, وهي دفاع الكاتب المستعمَر عن لغته ورفض تهميشها من خلال لغة المستعمِر, يتمثل بشكل اساسي في كتاب ليدنا ت. سميث “ازالة الاستعمار” كاحد النماذج التاريخية في مواجهة الاستعمار. اذ تمثل الكاتبة انعكاس وردة فعل حياتية واجهتها في فترة كان الاستعمار في بلدها يسعى لتهميش ومحو اللغة الماورية, لغتها ولغة السكان الاصليين في نيوزلندا, فانتجت هذا العمل الذي يمثل دراسة شاملة عن الاستعمار وازالته. ورغم كل ذلك فان كثافة الاثار الدالة على مفهوم الاستعمار المعاكس لا تتمثل في الكتاب وشخصية الكاتبة بقدر ما يتمثل في كلمة موجودة في عنوان كتابها وقد استخدمتها بصورة عبقرية لتمثل فعلاً لغوياً انتقامياً واستعماراً معاكساً. هذه الكلمة هي (Peoples) التي وضعتها في عنوانها “Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples” اذ ان كلمة people لا يمكن جمعها في اللغة الانكليزية. لكن الكاتبة جعلت منها جمعاً واضافتها ككلمة جديدة في اللغة الانكليزية وشرحت عنها قاصدةً بها شعوب السكان الاصليين. وما اصعب ان ياخذ مستعمَر ثأره من مستعمِر من خلال لغته بكسر قواعدها واضافة كلمات لها, رغم اعتقاد المستعمِر ان هذا الامر بسيط جداً وليس بانجاز. الا انه يمثل صلب مفهوم الاستعمار المعاكس.
هذه الاثار كلها تقودنا الى المفهوم الشامل الذي وضحه هنتنجتون في كتابه, اذ يرجعها الى ثنائية الاصالة اللغوية واللغة الاستعمارية المتبناة في المنهجية التعليمية للبلد المستعمَر. وبالرغم ان هنتنجتون يرجع ذلك الى تدهور القوة الغربية الاقتصادية والسياسية ايضاً, الا ان النتيجة الاساسية هي ما تهمنا الان والتي تثبت نظريتنا الخاصة في الاستعمار المعاكس:
“نهوض هذه التوجهات هو أحد تجليات ما يُسميه ((رونالدو دور)) بـ(الجيل الثاني لظاهرة التأصيل) في كلٍّ من المستعمرات الغربية السابقة والدول المستقلة مثل الصين واليابان، فإن (الجيل الأول للتحديث أو ما بعد الاستقلال كان يتلقَّى تعليمه غالبًا في الجامعات الأجنبية (الغربية) وبلغة غربية كوزموبوليتانية. وإلى حدٍّ ما لأنهم كانوا يذهبون إلى الخارج في مُقتبل العمر، قابلين للتأثر، ربما كان استيعابُهم للقيم الغربية وأساليب الحياة عميقًا) . . . ومع انحسار النفوذ الغربي، لا يستطيع القادة الصغار الطموحون أن يتطلَّعوا إلى الغرب لكي يزوِّدَهم بالقوة والثروة. عليهم أن يبحثوا عن وسائل النجاح في داخل مجتمعاتهم، ومن هنا فلا بد لهم من أن يتأقلموا مع القِيَم والثقافة المحلية.” (صدام الحضارات, ص127-128, مؤسسة هنداوي)
والنماذج التي استدل عليها هنتنجتون كانت تمثل حقاً ما يعنيه الكاتب وما نعنيه نحن في الاستعمار المعاكس على حد سواء. فـ(محمد علي جناح) الباكستاني و (لي كوان يو) السنغافوري هما خير دليل على انهم نتاج من نتاجات الاستعمار التعليمية, الا انهم خرجوا عليه ونادوا بالمُثُل التي يلقنون بها شعبهم, الشعب المستعمِر, ولا يطبقونها في ارض المتعلمين المستعمَره. بل نضيف الى قائمة هنتنجتون مهاتما غاندي الذي كان مثلهم طالب قانون في جامعات المستعمِرين, الا انه اصبح بعدها محرر الهند من الدولة التي علمته, وغيرهم الكثير. ان الاستعمار المعاكس يثبت اذاً ان المستعمِر هو ما يصنع الذين سيحاربونه وليس فقط الذين سياخذون مناصب في دولته يوماً.
فهمنا الان تحقق الاستعمار المعاكس من خلال اللغة حسب تسلسل القصة التي فرضناها. ونكمل على اثرها للعمود الجوهري الثاني وهو التفوقية. ان سردية المستعمِر المفترضة مبنية على ان ما يملكه يكفيه لتميزه عن المستعمَر. وان المستعمَر حتى وان امتلك يوماً ما يمتلكه المستعمِر لن يجيد استخدامه وابداعه فيه ولن يتغلب على اصحابه الاوائل ابداً. لكن الشعوب المستعمَره لا تبقى على هذه الرؤية مدة طويلة اذ من المستحيل ان نرى شعباً يؤمن باكمله ان الذي استعمره افضل منه بالكامل, فتكون ضريبة تفوقه هو استعماره.
والصور التاريخية الساخرة ترينا ان كل مستعمِر اما انه يتهاون تدريجياً في حساب احتمالية سقوط الجانب التفوقي في سرديته الاستعمارية او ينفي عن هذا الاحتمال بشكل كامل, الى ان ياتي الوقت وينصدم فيه ان المستعمَر لم يسقط الرؤية التفوقية في عقله اللاواعي فقط, بل تجاوزه واصبح متوفقاً على مستعمِره بصورة مذهلة.
وتكثر الشواهد في هذا المجال لدرجة استحالة حصرها, الا اننا سنقدم شاهداً واحداً تاريخياً سيغنينا عن الاتيان بغيره وهو رياضة الكريكيت البريطانية. والتي اصبحت الان رياضة هندية بامتياز, لدرجة اننا نجد افراداً انكليزيين يسعون للعب والاحتراف, في اللعبة التي نشأت في ارضهم, في الهند وليس في ارضهم. ان الاستعمار المعاكس في هذا الشاهد يتجلى في احد اهم الاعمال السينمائية التاريخية في الهند وهو فلم “لاغان” او “الضريبة” “Lagaan: Once Upon a Time in India” الذي مزج بين التاريخ الاستعماري في الهند والتحرر منه من خلال كسر فكرة التفوقية التي هشمت رؤى الشعب المستعمَر.
من المدهش ان يكون كل جزء في هذا الفلم هو رمزية لمحاربة الاستعمار والاستعمار المعاكس وكسر مفهوم التفوقية في السردية الاستعمارية بدءاً من الشخصيات ووصولاً الى الحوار. فاما الشخصيات فنرى ان اسم بطل القصة (بوفان) يعني الارض والوطن والتضحية في اللغة الهندية, اي ان بطل القصة لا يمثل فكرة الشعب بل الارض ككل, واستهانة واستخفاف البريطانيين به هي ما تمثل استهانتهم بالمستعمَر ككل.
وهنا يلعب الحوار والعرض دوره في ابراز فكرة الاستعمار المعاكس, اذ ان البريطانيين يتحدون بوفان واهل قريته بان ينتصروا عليهم بلعبة الكريكيت بعد ان سخر بوفان من لعبتهم, ومقابل ذلك سيكون هناك اعفاء من الضرائب لثلاث سنوات, فان خسروا سيدفعون ثلاثة اضعاف الضريبة من المحاصيل التي ينتجونها في سنتهم التي كانت شحيحة المطر. وتتضح هنا النقطة المفصلية التي حولت المشهد ان يكون بهذا الشكل وهي مكنونة في عنوان الفلم وهو (الضريبة), اذ نرى رد بوفان على اهل قريته بعد ان غضبوا عليه لموافقته بالقول: “وماذا ان رفضت, هل بامكانكم ان تجمعوا ضعف الضريبة في هذه السنة من الاساس؟” اي ان الضريبة هي الرمزية الاستعمارية التي يستخدمها المستعمِر لتمرير سردية التفوق للمستعمَر, لكنها تتحول في لحظة زمنية مفاجئة الى شك ومسعى من الاخير فتكون بعدها انتصار الاخير وتحرره من خلال سلاح المستعمِر واسقاط الرؤية التفوقية التي كان ينادي به.
ان بوفان, الارض والوطن, لم يكن يحمل عصا الكريكيت في الفلم كرمزية لمواجهة الاستعمار ومحاربته فحسب, بل كان تحدياً لمفهوم يستخدمه ويستغله المستعمِر ضد المستعمَر. فيكون انتصار المستعمَر هي اللحظة التي تسقط بها السردية الاستعمارية وتكتمل بها احد مراحل الاستعمار المعاكس. ان رد بوفان على ديفا, احد الشخصيات الثانوية بالفلم, حين سأله عن التصدي للاستعمار وقال له: “نعم, لكن ليس بالعصي ولا بالرماح. بالكرة والمضرب.” هو دلالة اولية على ان كل تحدي يفعله المستعمَر ضد المستعمِر يمثل مهمة وطنية وقضية تصدي للاستعمار. ويتجلى ذلك في رد ديفا عليه: “سواء بالعصي والرماح او بالكرة والمضرب, أريد ان اشارك في كل معركة ضد الانجليز.” ما يجعل مضرب الكريكيت في يد بوفان هو سلاح ضد المستعمِر من جانب واستعماراً معاكساً يتمثل بحمل الارض, بوفان, اداة المستعمِر وهزيمته بها من جانب اخر.
هذا التشكيل السردي تنطلي عليه ايمان المستعمَر بالرؤية التفوقية بشكل مؤقت وسذاجة المستعمِر به بشكله الدائم. ففلم لاغان (الضريبة) يثبت بصورة متكررة حقيقية تمثل تغطرس المستعمِر ورهبة المستعمَر, ثقة المستعمِر وشكوك المستعمَر, وغيرها من الثنائيات التي تتبلور في كل نقطة تاريخية عاش بها مجموعة من الناس هذا النوع من الصراع الاستعماري.
نستنتج من ذلك حقيقة النظام الاستعماري القديم وطريقته في تهميش هوية المستعمَر باضافة هوية المستعمِر عليه, فينتج الاستعمار المعاكس من خلال صراع بقاء هوية المستعمَر واسقاط هوية المستعمِر الى حد سلبه جزء او عدة اجزاء من هويته الاجتماعية العامة. وهذا مقرون في كل العصور وكل الامم التي استعمرت وخلقت مفهوماً استعمارياً معاكساً لها دون ان تقصد ذلك, فكان نصيب اهل العلم من الفتوحات العربية الاسلامية فارسياً وشرقياً اكثر من كونه عربياً, وسقطت فكرة العرق الابيض وتأخر الشرق مع الرئيس البريطاني السابق ريشي سوناك ذا الاصول الهندية وحتى مع العمدة المرشح الجديد لولاية نيويورك زهران ممداني.
ان العالم اذاً لا يحتاج ان يرى الاستعمار المعاكس في شخص فرانس فانون وكتابه كشخصية فرنسية ذات اصول افريقية واجهت الفكرة الاوروبية, بل يكفيه ان يرى الشخوص السياسية والرياضية والاجتماعية المؤثرة في اوروبا واصولهم الشرقية والافريقية كاحد علامات الانتصار الحقيقي.
لا تقف المسألة عند هذا الحد في قضية الرؤية التفوقية, بل تتجاوز ذلك لتصل الى المفاهيم الحضارية الشاملة التي مرت بها البشرية عبر التاريخ. فكل الروح الغربية التي بنت فيها استعمارها قد اتت اصولها من افكار قديمة بنت عليها سرديتها التفوقية, وسناخذ الجانب الديني كمثال اخير لجوهر الرؤية التفوقية في الاستعمار. فنحن نعلم جيداً ان الفكرة الاوروبية قد بنت اساساتها الدينية على المسيحية بشكل كامل, اذ كان الغطاء الديني مسيحياً دائماً واحد دلالاته كانت كتاب “روح الشرائع” للكاتب مونتسيكو, والذي كتب باباً كاملاً تحت عنوان: “الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام” وليس عجيباً ان نرى نتاجات وهيكلية هذه الفكرة موجودة الى يومنا هذا.
لكن هل الاستعمار الاوروبي نجح في الحفاظ على هذه السردية التفوقية الى اليوم؟ ان ظاهر العالم وباطنه يجيباننا بلا جدال بالنفي. واكبر الاشارات دلالة على سقوط هذه السردية وتحقيقها استعماراً معاكساً هو المفكر الفلسطيني وائل حلاق, اذ يقدم في افكاره نموذج الاسلام السياسي التاريخي كحل للمنطقة الشرقية والغربية ويقول, عكس مونتسكيو, ان الاسلام هو اصلح نظام سياسي عكس المسيحية التي تصنع نظماً استبدادية وامبريالية. نعم, ان وائل حلاق يصنع من ذاته, من غير قصد, مونتسكيو الشرق في العصر الحديث. ومن يؤكد نبوئته في رجوع انتشار الاسلام, سواء على الصعيد المجتمعي او السياسي, هو هنتنجتون بذاته حين يقول:
“وفي المجتمعات سريعة التحديث، عندما لا تكون الأديان أو العقائد الشعبية قادرة على التأقلم مع متطلبات التحديث، تُوجَد الإمكانية لانتشار المسيحية الغربية والإسلام. وفي تلك المجتمعات يظلُّ أكثر أبطال الثقافة الغربية نجاحًا، ليسوا طبقة الاقتصاديين المحدثين، ولا دعاة الديمقراطية المتحمِّسين ولا كبار موظفي المؤسسات متعددة الجنسيات … الأكثر نجاحًا هم المبشرون المسيحيون، والمرجَّح أن يظلوا كذلك . . . على المدى الطويل (محمد) سينتصر.” (صدام الحضارات, ص 89-90, ترجمة طلعت الشايب, مؤسسة هنداوي)
ان جزئية انتصار محمد هي صحيحة رغم ان الصورة التي اعتمد عليها هنتنجتون لايضاح الاسباب, كقضية النسل والتبشير وغيرها, ليست الصورة الكاملة لهذا الانتصار المنتظر. فالاغلبية الدينية اللغوية, اسلام عربي شرقي ومسيحية انكليزية غربية, هي ليست الا ادوات لمنظومات استعمارية تاريخية استطاعت من خلال ارثها الفكري ان تحقق الاغلبية السكانية في العالم في فترة من الفترات. لكن كما ان العرب والاسلام سقط كقوة عظمى في التاريخ الحديث من خلال الاستعمار الغربي المعاكس, يبدأ الان فصل جديد تعيشه منظومة الاسلام العربي كاستعمار معاكس ضد الغرب. وهذا ما لم يعي له هنتنجتون رغم صحة كل ما اشار اليه.
نصل الى اخر جزء من فرضيتنا الاستعمارية وهو مفهوم الاختلاف. فالكيان الاجتماعي المستعمِر لن يكفيه الايمان ونشر فكرة التفوقية واللغة فقط, بل يحتاج ان يرسخ مفهوم الاختلاف, او انا/الاخر, لكي يضمن بقاء الرؤية التفوقية لاطول فترة ممكنة. وكانت الرمزية العنصرية التي اضافها كونراد في روايته “قلب الظلام” هي احد النماذج المشهورة في فكرة الاختلاف, اذ ان العيون قد توجهت صوب السكان الاصليين الذين اكلوا بعضهم البعض متسائلاً عن انسانيتهم, ومشيراً في بداية روايته الى قصص السفن التائهة الثلاث التي نقلت الاساطير الاوروبية عنهم انهم اكلوا بعضهم البعض, كي يترك الكاتب تساؤلاً ينسف مفهوم الاختلاف وهو تشابه نفس الفعل لكن مع المجموعة التي تدعي التحضر والمجموعة التي يجب ان تكون هذه السمة هي دلالة على وحشيتهم.
بامكاننا القول ان اعظم الامثلة على مفهوم الاختلاف, كعمود جوهري استعماري, هو العنصرية اللونية, حتى تجلى ذلك على شكل بيولوجي وثقافي وحضاري وحتى اقتصادي. وكان المثال الذي نقله فانون لنظرية تأخر نمو عقل السكان الاصليين هو خير مثال على تجذير مفهوم الاختلاف في المنظومة الاوروبية. لكن النتيجة لم تكن ابداً من صالح اوروبا ولم يدم حتى مفهوم الاختلاف الذي كان طوقاً لفكرتها الاستعمارية, فوجود فرانس فانون, كشخص فرنسي الجنسية, قد نسف بفكره ولونه معاً النظرة الاستعمارية الاوروبية واصبح احد الامثلة التاريخية على ذلك.
على الجانب الاخر, تبرز رؤيتنا للمنتخب الفرنسي لكرة القدم وهو يحمل بالكامل ذوي البشرة السوداء ويحمل لاعبين تاريخيين من اصول افريقية. وهو ما يبين التآكل الفكري للمفاهيم الجوهرية التي انبنت عليها اوروبا وزيادة صراعاتها المجتمعية الداخلية. فخسارة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 قد حمل في طياته شهادة سقوط اخر عمود جوهري اثر مخالب الاستعمار المعاكس.
لكن هذه الدلالات لا تكفي لفهم المراحل التاريخية التي اوصلت الشعوب المستعمَرة لاخذ ثأرها وتحقيق الاستعمار المعاكس من المستعمِرين باسقاط مفهوم الاختلاف. فهناك عوامل متراكمة قد ساهمت في تحقيق ذلك البعد من فرضيتنا الاستعمارية. واحد هذه العوامل التي سنكتفي ونختم بها هي: ((الهجرة)).
ان الاستعمار الاوروبي, وهو يساهم في دعم الحكومات الاستبدادية في الشرق او حتى في دائرة حكمه الاستعماري لكيان مجتمعي ما, قد ساهم من غير قصد في زيادة الهجرة السكانية الى اراضيه طلباً لمقومات الحياة الطبيعية والانسانية التي حرمه الاستعمار منها في ارضه. ولا ياتي المهاجرون وهم راضين على ذلك او مستعدين لتغيير نمطية حياتهم الفكرية والدينية. فتنشئ قوة داخل قوى الدولة وهي قوة المهاجرين الذين سيصبحون, هم او اطفالهم, جزءً من الكيان المجتمعي المستعمِر, اي انه سرطان داخل جسد المستعمِر سيجبره على تغيير كثير من اسسه السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية.
بهذه المنهجية, يخلق المستعمِر استعماراً معاكساً داخل ارضه ويجبره على ضرب نفسه من الداخل. فالمظاهرات العالمية ضد الكيان الاسرائيلي اليوم تأتي اغلبها من اوروبا الداعمة بشكل كامل لهذا الكيان, وان ابرز القيادات والمفكرين والباحثين الذين رفعوا راية الثورة والتغيير لاجل الشرق قد درسوا في جامعات المستعمِرين من الاساس, من مهاتما غاندي لمحمد علي جناح لعلي شريعتي وحتى فانون ومحمد اركون وغيرهم. باختصار, يتحقق الاستعمار المعاكس بكسر اللغة والتفوقية داخل ارض المستعمَر, لكن الاختلاف لا ينكسر الا داخل ارض المستعمِر حتى تكون رصاصة الرحمة له بتهميش كيانه المجتمعي وجعله متعدداً. وهذا هو الاساس الذي يبحث عنه الشعب الامريكي اليوم على يد ترامب حين يريدون طرد المهاجرين غير الشرعيين من امريكا, فما هي امريكا دون المهاجرين؟ وهل يكفي ان يكون زهران ممداني ذي الاصل العربي والخلفية اليسارية كافياً لعدم اهليته لاخذ منصب مهم وحساس في الاراضي الامريكية؟
فهمنا الان كيف ساهمت الهجرة في تحقيق الاستعمار المعاكس من خلال كسر مفهوم الاختلاف وداخل ارض المستعمِر. وكدليل اخير على استيعاب اوروبا والغرب العالمي لتلك الحقيقة هو مساعيهم الحالية لتقليل الهجرة وهي بالواقع قلت بدون ان يساهموا في الجزء الاكبر من هذه الفكرة. فنرى هنتنجتون قد تنبأ بان الهجرة الى الغرب ستقل في هذه السنة التي اصدرنا فيها هذا المقال اذ قال:
“مشكلة الغزو الإسلامي الديموغرافي على أية حال من المرجح أن تضعف، حيث إن معدلات النمو السكاني في مجتمعات شمال أفريقيا والشرق الأوسط تصل إلى أعلى مستوياتها ثم تبدأ في الهبوط كما حدث في بعض الدول. وطالما أن الضغط الديموغرافي يدفع إلى الهجرة، فإن الهجرة الإسلامية يمكن أن تقل بحلول عام ٢٠٢٥ م، وإن كان هذا لا ينطبق على دول شبه الصحراء الإفريقية.” (صدام الحضارات, ص 266-267, مؤسسة هنداوي)
وقد صح تنبؤ هنتنجتون اليوم وليس على صعيد الشرق-اوروبا فقط بل حتى على امريكا-المكسيك ايضاً. فالاراضي الامريكية وحكومتها تحمل تاريخاً استعمارياً دموياً واستغلالاً امبريالياً موجود الى اليوم. لكن امريكا تدفع في الوقت نفسه ضريبة ذلك على شكل استعمار معاكس يحاول ترامب اليوم جاهداً ان يمنع حدوثه وتدفقه, الا انه يستحيل ان يوقف او يمحي ما حدث تاريخياً من اغتصاب الاراضي المكسيكية وتهميش مجتمعها.
ببساطة, لقد سعت الرؤية الاستعمارية الغربية تجريد اراضينا من مفاهيم الحرية من خلال دعم الحركات التطرفية والحكومات الاستبدادية. في الوقت نفسه ذهب الكثير من العرب, لاغراض اكاديمية او غير اكاديمية, الى الغرب فاكتسبوا ما يمنحونه لشعبهم ويحرمونه للشعوب التي اتت لهم. فتنقلب هذه المجاميع كلهم داخل ارض المستعمِر الحديث على وفق الفكرة التي سعى طول مسعاه ان يحرمها من الشعب المستعمَر. نعم, ان المستعمِر هو الحارم لهؤلاء في ارضهم لمفاهيم الحرية وتقرير المصير, لكنه لا يستطيع فعل ذلك وهم في ارضه. فيتحقق بهذا الشكل الاستعمار المعاكس.
بعد اكتمال الصورة التي افترضناها عن الاستعمار, بات واضحاً لنا ماهية الاستعمار المعاكس وتعريفه الى ان تصح لنا فرصة في الاسهاب عنه اكثر في كتاب. انه احتلال الشعوب المستعمَره للشعوب المستعمِره كثأر استعمارها وسفك دماءها وتهميش ذاتها وتحطيم تراثها ووجودها. ان الاستعمار, في بدايته, ليس استعمار شعب او دولة على اخرى, فليست كل الشعوب مؤمنة بالاستعمار ان لم يكن كل الشعوب لا تؤمن بذلك فطرياً, بل هي فكرة يؤمن بها القادة والحكام والرؤساء وعاليي الشأن من المجتمع. فيضطرون اولئك المجموعة بزرع فكرة استعمارية تبريرية لشعبهم ودفعه لاتجاه هذا الاتجاه. نعم, ان الاستعمار في اوله استعمار الحكام على شعوبهم, لكي يدفعوا شعبهم لاستعمار غيرهم. وهو بدوره ماهدة بسيطة لصنع الاستعمار المعاكس في ارض المستعمِر من قبل المستعمَر.
وقد تتساءلون في نهاية هذا المقال المطول نسبياً عن حتمية حدوث الاستعمار المعاكس في كل زمان ومكان وامة فتقولون: هل كل امة مستعمِره ستُحدِث, هي والمستعمَر, استعماراً معاكساً مؤكداً حتى وان تم ابادة المستعمَر بالكامل؟ وبالتأكيد جوابنا النفي, فلو كان كذلك لما انتهت امم نعرف تاريخها اليوم وليس لها لا وجود ولا اثار في الذين استعمروهم, اللهم في احسن الاحوال تتجدد قضيتهم وتعلوا الاصوات التي تنادي بابادتهم لا غير. وخير دليل على ذلك الهنود الحمر الذين وجدوا قضيتهم اليوم في القضية الفلسطينية. وهذا ما يجعلنا في النهاية نؤكد على ان تحقيق ابادتنا بالكامل ممكن وليس مستحيل, وان الذي ينقذنا ليس التحرر من الاستعمار وليس ازالة الاستعمار بل الاستعمار المعاكس. هذا ما لم يدركه الاولون وندركه اليوم, وهذا هو الاكتشاف والانتصار المنتظر, ونسعى ان نستغله لتحررنا بعد ما مضى من العقود والقرون من الاستعمار. فالاستعمار المعاكس بدأ وحادث وما علينا الا استكمال تحقيقه حتى النهاية بايدينا وثورتنا العالمية
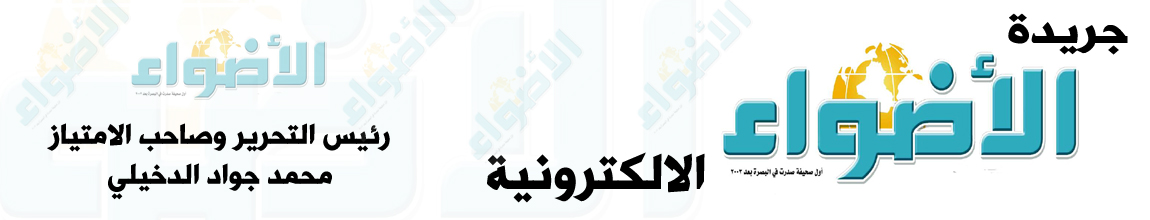 جريدة الاضواء الالكترونية
جريدة الاضواء الالكترونية